الأقسام

مشروع الإحياء مدونة توفر مقالات تعليمية هادفة في مختلف المجالات

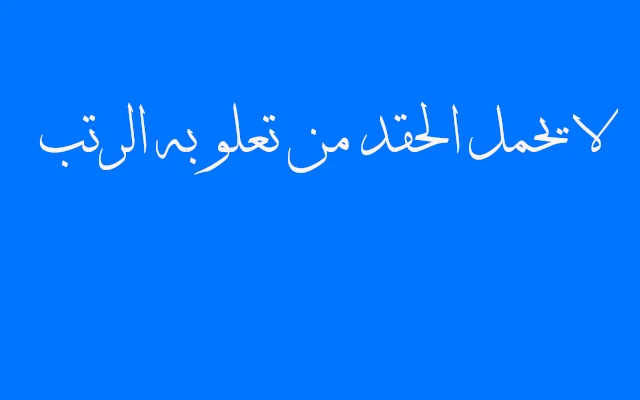
هو عنترة بن شداد العبسي، أحد أشهر شعراء العرب في العصر الجاهلي، وله معلقته المشهورة التي يبدأ فيها قائلا [الكامل]:
هل غادر الشعراء من متردم * أم هل عرفت الدار بعد توهم
اشتهرت تلك القصيدة حتى صارت تعد من المعلقات السبعة.
وتفعيلة بحر البسيط هي: مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن
لا يمكن تحديد مناسبة معينة تحديدا، ولكن عنترة قالها يفخر بقومه ويتوعد النعمان بن المنذر.
لا يحْمِلُ الحِقْدَ مَنْ تَعْلُو بِهِ الرُّتَبُ
ولا ينالُ العلى من طبعهُ الغضبُ
ومن يكنْ عبد قومٍ لا يخالفهمْ
إذا جفوهُ ويسترضى إذا عتبوا
قدْ كُنْتُ فِيما مَضَى أَرْعَى جِمَالَهُمُ
واليَوْمَ أَحْمي حِمَاهُمْ كلَّما نُكِبُوا
لله دَرُّ بَني عَبْسٍ لَقَدْ نَسَلُوا
منَ الأكارمِ ما قد تنسلُ العربُ
لئنْ يعيبوا سوادي فهوَ لي نسبٌ
يَوْمَ النِّزَالِ إذا مَا فَاتَني النَسبُ
إِن كُنتَ تَعلَمُ يا نُعمانُ أَنَّ يَدي
قَصيرَةٌ عَنكَ فَالأَيّامُ تَنقَلِبُ
إِنَّ الأَفاعي وَإِن لانَت مَلامِسُها
عِندَ التَقَلُّبِ في أَنيابِها العَطَبُ
اليَومَ تَعلَمُ يا نُعمانُ أَيَّ فَتًى
يَلقى أَخاكَ الَّذي قَد غَرَّهُ العُصَبُ
فَتًى يَخُوضُ غِمَارَ الحرْبِ مُبْتَسِمًا
وَيَنْثَنِي وَسِنَانُ الرُّمْحِ مُخْتَضِبُ
إنْ سلَّ صارمهُ سالتَ مضاربهُ
وأَشْرَقَ الجَوُّ وانْشَقَّتْ لَهُ الحُجُبُ
والخَيْلُ تَشْهَدُ لي أَنِّي أُكَفْكِفُهَا
والطّعن مثلُ شرارِ النَّار يلتهبُ
إذا التقيتُ الأعادي يومَ معركة ٍ
تَركْتُ جَمْعَهُمُ المَغْرُور يُنْتَهَبُ
لي النفوسُ وللطّيرِ اللحومُ وللـ
ـوحْشِ العِظَامُ وَلِلخَيَّالَة ِ السَّلَبُ
لا أبعدَ الله عن عيني غطارفة ً
إنْسًا إذَا نَزَلُوا جِنَّا إذَا رَكِبُوا
أسودُ غابٍ ولكنْ لا نيوبَ لهم
إلاَّ الأَسِنَّة ُ والهِنْدِيَّة ُ القُضْبُ
تعدو بهمْ أعوجيِّاتٌ مضَّمرة ٌ
مِثْلُ السَّرَاحِينِ في أعناقها القَببُ
ما زلْتُ ألقى صُدُورَ الخَيْلِ منْدَفِقًا
بالطَّعن حتى يضجَّ السَّرجُ واللَّببُ
فالعميْ لو كانَ في أجفانهمْ نظروا
والخُرْسُ لوْ كَانَ في أَفْوَاهِهمْ خَطَبُوا
والنَّقْعُ يَوْمَ طِرَادِ الخَيْل يشْهَدُ لي
والضَّرْبُ والطَّعْنُ والأَقْلامُ والكُتُبُ
إذا لنشرح الأبيات بيتا بيتا.
لا يحْمِلُ الحِقْدَ مَنْ تَعْلُو بِهِ الرُّتَبُ
ولا ينالُ العلى من طبعهُ الغضبُ
ومن يكنْ عبد قومٍ لا يخالفهمْ
إذا جفوهُ ويسترضى إذا عتبوا
يبدأ عنترة قصيدته ببيتين من الحكمة، فيقول أن الحاقد لو أن منزلته رفيعة وتعلو به لما حمل هذا الحقد، وأن الذي طبعه الغضب يؤدي لنفور الناس منه فلا ينال المنزلة الرفيعة التي يريدها، وأن الشخص الذليل الذي يرضى أن يكون عبدا لقومه- دائما يتبعهم ولا يخالفهم أبدا،
وربما تقول أن "ومن يكن عبد قوم فإذا جفوه لا يخالفهم
، وكذلك الأمر بالنسبة لـ"
وما يفعله عنترة من الحكمة في القصيدة ليس بجديد على العرب، فالعرب دائما وأبدا كانوا يحبون أن يقولوا الحكمة في قصائدهم، ألم تر زهير بن أبي سلمى يقول في معلقته الشهيرة:
وأعلم علم اليوم والأمس قبله
ولكنني عن علم ما في غد عم
ومن يجعل المعروف من دون عرضه
يفره ومن لا يتق الشتم يشتم
ومن هاب أسباب المنايا ينلنه
وإن يرق أسباب السماء بسلم
وغيرها من أبيات الحكمة الجميلة التي قالها زهير بن أبي سلمى في معلقته الرائعة.
قدْ كُنْتُ فِيما مَضَى أَرْعَى جِمَالَهُمُ
واليَوْمَ أَحْمي حِمَاهُمْ كلَّما نُكِبُوا
لله دَرُّ بَني عَبْسٍ لَقَدْ نَسَلُوا
منَ الأكارمِ ما قد تنسلُ العربُ
كلمة درَّت الدنيا على أهلها
: أي كثر عطاؤها وخيرها، ودر اللبن أي كثر، ودرت السماء بالمطر: أي صبته كثيرا، فالفعل در يأتي بمعنى الخير والكثرة.
لله دَرُّك
أي لله خيرك وفعالك، ويقال للذم لا دَرَّ دَرُّك
أي لا كثر عملك ولا زكا.
والأكارم: جمع أكرم، والكرم ضد اللؤم، فاللؤم هو دناءة الآباء، والكرم شرف النسب، فهو يقول أن بني عبس قد نسلوا أكرم ما قد تنسل العرب.
لئنْ يعيبوا سوادي فهوَ لي نسبٌ
يَوْمَ النِّزَالِ إذا مَا فَاتَني النَسبُ
ولله لئن...
، فاستخدام
فهو يقول:
وسواد عنترة شيء كان يذكره بكثرة في شعره لأن العرب كانت تعيره بذلك، فنجده يقول مثلا:
يعيبون لوني بالسواد جهالة
ولولا سواد الليل ما طلع الفجر
وإن كان لوني أسودا فخصائلي
بياض ومن كفيَّ يستنزل القطر
إِن كُنتَ تَعلَمُ يا نُعمانُ أَنَّ يَدي
قَصيرَةٌ عَنكَ فَالأَيّامُ تَنقَلِبُ
يقال
إِنَّ الأَفاعي وَإِن لانَت مَلامِسُها
عِندَ التَقَلُّبِ في أَنيابِها العَطَبُ
الفعل
اليَومَ تَعلَمُ يا نُعمانُ أَيَّ فَتًى
يَلقى أَخاكَ الَّذي قَد غَرَّهُ العُصَبُ
فهو يخاطب النعمان قائلا:
فَتًى يَخُوضُ غِمَارَ الحرْبِ مُبْتَسِمًا
وَيَنْثَنِي وَسِنَانُ الرُّمْحِ مُخْتَضِبُ
فتى
الأولى.
وخاض غمار الحرب: أي اقتحمها محاربا.
فعنترة يقول:
إنْ سلَّ صارمهُ سالتَ مضاربهُ
وأَشْرَقَ الجَوُّ وانْشَقَّتْ لَهُ الحُجُبُ
سل الشعرة من العجين
وسل السيف من غمده
.
فهو يقول:
والخَيْلُ تَشْهَدُ لي أَنِّي أُكَفْكِفُهَا
والطّعن مثلُ شرارِ النَّار يلتهبُ
إذا التقيتُ الأعادي يومَ معركة ٍ
تَركْتُ جَمْعَهُمُ المَغْرُور يُنْتَهَبُ
لي النفوسُ وللطّيرِ اللحومُ وللـ
ـوحْشِ العِظَامُ وَلِلخَيَّالَة ِ السَّلَبُ
ثم يمدح عنترة أسياد قومه فيقول:
لا أبعدَ الله عن عيني غطارفة ً
إنْسًا إذَا نَزَلُوا جِنَّا إذَا رَكِبُوا
أسودُ غابٍ ولكنْ لا نيوبَ لهم
إلاَّ الأَسِنَّة ُ والهِنْدِيَّة ُ القُضْبُ
تعدو بهمْ أعوجيِّاتٌ مضَّمرة ٌ
مِثْلُ السَّرَاحِينِ في أعناقها القَببُ
وقَبَّ يقُبُّ قَبًّا *وقَبَبًا: أي دق خصره وضمر بطنه، فهو أقب وهي قباء.
ما زلْتُ ألقى صُدُورَ الخَيْلِ منْدَفِقًا
بالطَّعن حتى يضجَّ السَّرجُ واللَّببُ
(اللبب: سَيْر يُشدُّ إلى حِزام السَّرْج، مارًّا بين قائمتَي الفرس الأماميَّتين حتّى يتّصل باللِّجام)
 |  |
السرج | اللبب |
فالعميْ لو كانَ في أجفانهمْ نظروا
والخُرْسُ لوْ كَانَ في أَفْوَاهِهمْ خَطَبُوا
والنَّقْعُ يَوْمَ طِرَادِ الخَيْل يشْهَدُ لي
والضَّرْبُ والطَّعْنُ والأَقْلامُ والكُتُبُ