الأقسام

مشروع الإحياء مدونة توفر مقالات تعليمية هادفة في مختلف المجالات

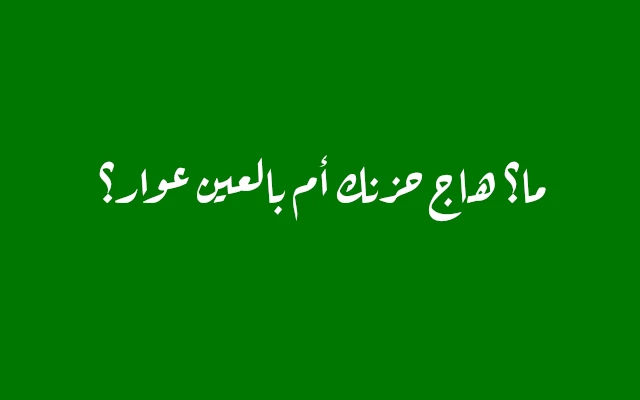
هي تُماضر بنت عمرو، ولُقبت بالخنساء لارتفاع أرنبتي أنفها، هي شاعرة عاصرت العصر الجاهلي وصدر الإسلام، اشتهرت بشعرها في رثاء أخيها صخر.. وبالذات برائيتها التي نقرؤها معا في هذا الشرح..
دمجتُ في هذه القصيدة روايات عدة معا، إذ توجد أبيات في هذه القصيدة مروية بأكثر من طريقة، كأول بيت مروي قذى بعينك أم بالعين عوار
ومروي أيضا ما هاج حزنك أم بالعين عوار
، أو البيت السابع عشر مروي أغر أبلج تأتم الهداة به
ومروي وإن صخرا لتأتم الهداة به
. أخذت الرواية بداية من ديوان الخنساء بشرح ثعلب، ثم عدلت الرواية وأخذت أبياتا معينة من روايات أخرى لتسهيل الشرح لأن الروايات الأخرى في تلك الأبيات أبسط أو أسهل أو أجمل بالنسبة لي، كما حذفت بيتين من رواية ثعلب لأنه توجد روايات أخرى ليس فيها البيتان ورأيت أن أختصر بحذفهما. وصواب هذه القرارات خاضع للآراء الشخصية لذا قد لا يكون الحذف والتبديل أفضل قرار بالنسبة لكل الناس.
مَا؟ هَاجَ حُزْنُكِ أَمْ بِالْعَيْنِ عُوَّارُ؟
أَمْ ذَرَّفَتْ أَمْ خَلَتْ مِنْ أَهْلِهَا الدَّارُ؟
كَأَنَّ عَيْنِي لِذِكْرَاهُ إِذَا خَطَرَتْ
فَيْضٌ يَسِيلُ عَلَى الْخَدَّيْنِ مِدْرَارُ
تَبْكِي لِصَخْرٍ هِيَ الْعَبْرَى وَقَدْ وَلِهَتْ
وَدُونَهُ مِنْ جَدِيدِ التُّرْبِ أَسْتَارُ
تَبْكِي خُنَاسٌ فَمَا تَنْفَكُّ مَا عَمَرَتْ
لَهَا عَلَيْهِ رَنِينٌ وَهْيَ مِفْتَارُ
تَبْكِي خُنَاسٌ عَلَى صَخْرٍ وَحَقَّ لَهَا
إِذْ رَابَهَا الدَّهْرُ إِنَّ الدَّهْرَ ضَرَّارُ
لَا بُدَّ مِنْ مِيتَةٍ فِي صَرْفِهَا غِيَرٌ
وَالدَّهْرُ فِي صَرْفِهِ حَوْلٌ وَأَطْوَارُ
قَدْ كَانَ فِيكُمْ أَبُو عَمْرٍو يُسُودُكُمُ
نِعْمَ الْمُعَمَّمُ لِلدَّاعِينَ نَصَّارُ
صُلْبُ النَّحِيزَةِ وَهَّابٌ إِذَا مَنَعُوا
وَفِي الْحُرُوبِ جَرِيءُ الصَّدْرِ مِهْصَارُ
يَا صَخْرُ وَرَّادَ مَاءٍ قَدْ تَنَاذَرَهُ
أَهْلُ الْمَوَارِدِ، مَا فِي وِرْدِهِ عَارُ
مَشَى السَّبَنْتَى إِلَى هَيْجَاءَ مُضْلِعَةٍ
لَهُ سِلَاحَانِ أَنْيَابٌ وَأَظْفَارُ
فَمَا عَجُولٌ عَلَى بَوٍّ تُطِيفُ بِهِ
لَهَا حَنِينَانِ إِصْغَارٌ وَإِكْبَارُ
تَرْتَعُ مَا رَتَعَتْ حَتَّى إِذَا ادَّكَرَتْ
فَإِنَّمَا هِيَ إِقْبَالٌ وَإِدْبَارُ
لَا تَسْمَنُ الدَّهْرَ فِي أَرْضٍ وَإِنْ رُبِعَتْ
فَإِنَّمَا هِيَ تَحْنَانٌ وَتَسْجَارُ
يَوْمًا بِأَوْجَدَ مِنِّي يَوْمَ فَارَقَنِي
صَخْرٌ، وَلِلدَّهْرِ إِحْلَاءٌ وَإِمْرَارُ
وَإِنَّ صَخْرًا لَكَافِينَا وَسَيِّدُنَا
وَإِنَّ صَخْرًا إِذَا نَشْتُو لَنَحَّارُ
وَإِنَّ صَخْرًا لَمِقْدَامٌ إِذَا رَكِبُوا
وَإِنَّ صَخْرًا إِذَا جَاعُوا لَعَقَّارُ
وَإِنَّ صَخرًا لَتَأتَمَّ الهُداةُ بِهِ
كَأَنَّهُ عَلَمٌ فِي رَأْسِهِ نَارُ
جَلْدٌ جَمِيلُ الْمُحَيَّا كَامِلٌ وَرِعٌ
وَلِلْحُرُوبِ غَدَاةَ الرَّوْعِ مِسْعَارُ
نَحّارُ راغِيَةٍ مِلجاءُ طاغِيَةٍ
فَكّاكُ عانِيَةٍ لِلعَظمِ جَبّارُ
حَمَّالُ أَلْوِيَةٍ هَبَّاطُ أَوْدِيَةٍ
شَهَّادُ أَنْدِيَةٍ لِلْجَيْشِ جَرَّارُ
فَقُلْتُ لَمَّا رَأَيْتُ الدَّهْرَ لَيْسَ لَهُ
مُعَاتِبٌ؛ وَحْدَهُ يُسْدِي وَنَيَّارُ
لَقَدْ نَعَى ابْنُ نَهِيكٍ لِي أَخَا ثِقَةٍ
كَانَتْ تُرَجَّمُ عَنْهُ قَبْلُ أَخْبَارُ
فَبِتُّ سَاهِرَةً لِلنَّجْمِ أَرْقُبُهُ
حَتَّى أَتَى دُونَ غَوْرِ النَّجْمِ أَسْتَارُ
لَمْ تَرَهُ جَارَةٌ يَمْشِي بِسَاحَتِهَا
لِرِيبَةٍ حِينَ يُخْلِي بَيْتَهُ الْجَارُ
وَلا تَرَاهُ وَمَا فِي الْبَيْتِ يَأْكُلُهُ
لَكِنَّهُ بَارِزٌ بِالصَّحْنِ مِهْمَارُ
وَمُطْعِمُ الْقَوْمِ شَحْمًا عِنْدَ مَسْغَبِهِمْ
وَفِي الْجُدُوبِ كَرِيمُ الْجَدِّ مِيسَارُ
قَدْ كَانَ خَالِصَتِي مِنْ كُلِّ ذِي نَسَبٍ
فَقَدْ أُصِيبَ فَمَا لِلْعَيْشِ أَوْطَارُ
مِثْلُ الرُّدَيْنِيِّ، لَمْ تَدْنَسْ شَبِيبَتُهُ
كَأَنَّهُ تَحْتَ طَيِّ الْبُرْدِ أُسْوَارُ
جَهْمُ الْمُحَيَّا، تُضِيءُ اللَّيْلَ صُورَتُهُ
آبَاؤُهُ مِنْ طِوَالِ السَّمْكِ أَحْرَارُ
مُوَرَّثُ الْمَجْدِ مَيْمُونٌ نَقِيبَتُهُ
ضَخْمُ الدَّسِيعَةِ فِي الْعَزَّاءِ مِغْوَارُ
فَرْعٌ لِفَرْعٍ كَرِيمٍ غَيْرِ مُؤْتَشَبٍ
جَلْدُ الْمَرِيرَةِ عِنْدَ الْجَمْعِ فَخَّارُ
فِي جَوْفِ رَمْسٍ مُقِيمٌ قَدْ تَضَمَّنَهُ
فِي رَمْسِهِ مُقْمَطِرَّاتٌ وَأَحْجَارُ
طَلْقُ الْيَدَيْنِ بِفِعْلِ الْخَيْرِ ذُو فَجَرٍ
ضَخْمُ الدَّسِيعَةِ بِالْخَيْرَاتِ أَمَّارُ
لِيَبْكِهِ مُقْتِرٌ أَفْنَى حَرِيبَتَهُ
دَهْرٌ وَحَالَفَهُ بُؤْسٌ وَإِقْتَارُ
وَرُفْقَةٌ حَارَ هَادِيهِمْ بِمَهْلِكَةٍ
كَأَنَّ ظُلْمَتَهَا فِي الطُّخْيَةِ الْقَارُ
عَبْلُ الذِّرَاعَيْنِ قَدْ تُخْشَى بَدِيهَتُهُ
لَهُ سِلَاحَانِ أَنْيَابٌ وَأَظْفَارُ
لَا يَمْنَعُ الْقَوْمَ إِنْ سَالُوهُ خُلْعَتَهُ
وَلَا يُجَاوِزُهُ بِاللَّيْلِ مُرَّارُ
مَا؟ هَاجَ حُزْنُكِ أَمْ بِالْعَيْنِ عُوَّارُ؟
أَمْ ذَرَّفَتْ أَمْ خَلَتْ مِنْ أَهْلِهَا الدَّارُ؟
كَأَنَّ عَيْنِي لِذِكْرَاهُ إِذَا خَطَرَتْ
فَيْضٌ يَسِيلُ عَلَى الْخَدَّيْنِ مِدْرَارُ
تَبْكِي لِصَخْرٍ هِيَ الْعَبْرَى وَقَدْ وَلِهَتْ
وَدُونَهُ مِنْ جَدِيدِ التُّرْبِ أَسْتَارُ
تَبْكِي خُنَاسٌ فَمَا تَنْفَكُّ مَا عَمَرَتْ
لَهَا عَلَيْهِ رَنِينٌ وَهْيَ مِفْتَارُ
تَبْكِي خُنَاسٌ عَلَى صَخْرٍ وَحَقَّ لَهَا
إِذْ رَابَهَا الدَّهْرُ إِنَّ الدَّهْرَ ضَرَّارُ
تقول الشاعرة
لَا بُدَّ مِنْ مِيتَةٍ فِي صَرْفِهَا غِيَرٌ
وَالدَّهْرُ فِي صَرْفِهِ حَوْلٌ وَأَطْوَارُ
أي:
قَدْ كَانَ فِيكُمْ أَبُو عَمْرٍو يُسُودُكُمُ
نِعْمَ الْمُعَمَّمُ لِلدَّاعِينَ نَصَّارُ
صُلْبُ النَّحِيزَةِ وَهَّابٌ إِذَا مَنَعُوا
وَفِي الْحُرُوبِ جَرِيءُ الصَّدْرِ مِهْصَارُ
يَا صَخْرُ وَرَّادَ مَاءٍ قَدْ تَنَاذَرَهُ
أَهْلُ الْمَوَارِدِ، مَا فِي وِرْدِهِ عَارُ
كيف ذلك؟ أليس الصحيح ما في عدم ورده عار
؟
العرب أحيانا يكنون عن هذا النفي ويحذفونه، كقول المُرَقَّش:
ليس على طول الحياة ندم
ومن وراء المرءِ ما يعلم
فهو يقصد: ليس على عدم طول الحياة ندم على شيء، فطول الحياة يؤدي إلى الهَرَم والضعف.. وعليه نستنتج، أن الشاعرة تقول في ذلك البيت
مَشَى السَّبَنْتَى إِلَى هَيْجَاءَ مُضْلِعَةٍ
لَهُ سِلَاحَانِ أَنْيَابٌ وَأَظْفَارُ
فَمَا عَجُولٌ عَلَى بَوٍّ تُطِيفُ بِهِ
لَهَا حَنِينَانِ إِصْغَارٌ وَإِكْبَارُ
أين قالت ليست بأحزن مني
؟ لا أراها أكملت الجملة وتوقفت.
صبرا أيها القارئ، دعها تكمل جملتها في باقي الأبيات.
تَرْتَعُ مَا رَتَعَتْ حَتَّى إِذَا ادَّكَرَتْ
فَإِنَّمَا هِيَ إِقْبَالٌ وَإِدْبَارُ
لا زالت لم تخبر أن تلك الناقة ليست أحزن منها..
هلا صبرت قليلا أيها القارئ؟ إن التشبيه والتصوير في العصر الجاهلي كان يتميز بالدقة والبراعة، فهي تحاول المبالغة والدقة في تصويرها، فلا تصور نفسها بأي ناقة فحسب، بل تصف المشهد بكامل تفاصيله وأدقها..
لَا تَسْمَنُ الدَّهْرَ فِي أَرْضٍ وَإِنْ رُبِعَتْ
فَإِنَّمَا هِيَ تَحْنَانٌ وَتَسْجَارُ
يَوْمًا بِأَوْجَدَ مِنِّي يَوْمَ فَارَقَنِي
صَخْرٌ، وَلِلدَّهْرِ إِحْلَاءٌ وَإِمْرَارُ
وهذا ما كنت تنتظره أيها القارئ..
وكلمة بِأَوْجَدَ
هي خبر المبتدأ عَجُولٌ
في البيت الحادي عشر.. فهنا تختم جملتها، وتوضح مقصدها..
يا له من مشهد وتصوير دقيق!
دقة التصوير وكثرته من سمات الشعر الجاهلي وشعر صدر الإسلام.. فنرى الشعراء يصورون مشاهد بأدق تفاصيلها، وهذا دليل بالنسبة لي على خصوبة خيال الشعراء حينها.. فما رأيك؟
مثلا يقول كعب بن زهير في مقدمته الغزلية في البردة:
تَجْلُو عَوارِضَ ذي ظَلْمٍ إذا ابْتَسَمَتْ
كأنَّهُ مُنْهَلٌ بالرَّاحِ مَعْلُولُ
شُجَّتْ بِذي شَبَمٍ مِنْ ماءِ مَحنِيةٍ
صافٍ بأَبْطَحَ أضْحَى وهْوَ مَشْمولُ
تَنْفِي الرِّياحُ القَذَى عَنْهُ وأفْرَطُهُ
مِنْ صَوْبِ سارِيَةٍ بِيضٌ يَعالِيلُ
وبغض النظر عن الكثير من المفردات الغريبة في تلك الأبيات التي لا أريد شرحها حتى لا أعقد هذه القصاصة، فإن الشاعر يشبه ريق حبيبته
وفي نفس القصيدة ينتقل الشاعر لمدح الرسول
لَذاكَ أَهْيَبُ عِنْدي إذْ أُكَلِّمُهُ
وقيلَ: إنَّكَ مَنْسوبٌ ومَسْئُولُ
مِنْ خادِرٍ مِنْ لُيوثِ الأُسْدِ مَسْكَنُهُ
مِنْ بَطْنِ عَثَّرَ غِيلٌ دونَهُ غيلُ
يَغْدو فَيُلْحِمُ ضِرْغامَيْنِ عَيْشُهُما
لَحْمٌ مَنَ القَوْمِ مَعْفورٌ خَراديلُ
إِذا يُساوِرُ قِرْنًا لا يَحِلُّ لَهُ
أنْ يَتْرُكَ القِرْنَ إلاَّ وَهْوَ مَفلُولُ
مِنْهُ تَظَلُّ سَباعُ الجَوِّ ضامِزَةً
ولا تَمَشَّى بَوادِيهِ الأراجِيلُ
ولا يَزالُ بِواديهِ أخُو ثِقَةٍ
مُطَرَّحَ البَزِّ والدَّرْسانِ مَأْكولُ
أي: إن جلوسي أمام الرسول عَثَّرَ
، يصبح الأسد فيطعم شبليه لحما مقطعا من القوم، أسد لا يترك خصما إلا وخصمه مهزوم، أسد تخاف من بأسه الصقور والجوارح ولا تمشي بواديه حيوانات راجلة، وإذا مشى الرجل الشجاع الواثق بنفسه ذو السلاح والدرع بواديه فإنه لا يخرج إلا مأكولا..
فما رأيك في مشاهد التصوير في الشعر الجاهلي وصدر الإسلام.. هل تعجبك أم تراها معقدة؟
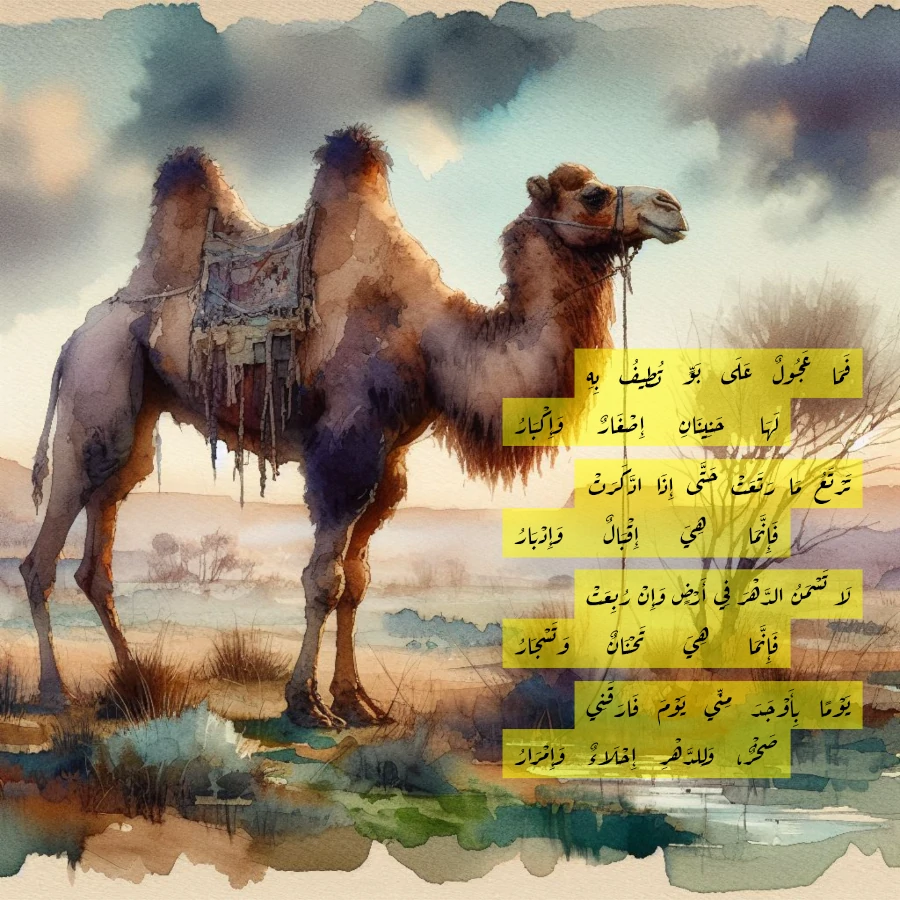
وَإِنَّ صَخْرًا لَكَافِينَا وَسَيِّدُنَا
وَإِنَّ صَخْرًا إِذَا نَشْتُو لَنَحَّارُ
وَإِنَّ صَخْرًا لَمِقْدَامٌ إِذَا رَكِبُوا
وَإِنَّ صَخْرًا إِذَا جَاعُوا لَعَقَّارُ
وَإِنَّ صَخرًا لَتَأتَمَّ الهُداةُ بِهِ
كَأَنَّهُ عَلَمٌ فِي رَأْسِهِ نَارُ
لعلك سمعت المثل الشعبي مثل النار على العلم
والذي يعني: مثل النار على قمة الجبل يراها جميع السائرين ليلا. وهذا المثل يشبه البيت السابق الذي قالته الخنساء في رثاء أخيها صخر:
وَإِنَّ صَخرًا لَتَأتَمَّ الهُداةُ بِهِ
كَأَنَّهُ عَلَمٌ في رَأسِهِ نارُ
وأصل هذا أن العرب المسافرون ليلا كانوا إذا رأوا نارا بعيدة استدلوا بها على وجود ناس هناك فساروا إليها وطلبوا الضيافة من أهلها...
فضرب العرب المثل في الكرم لمن لا يخمد النار ولا يستثقل الضيوف، فمثلا يقول السموأل فخرا:
وَما أُخمِدَت نارٌ لَنا دونَ طارِقٍ
وَلا ذَمَّنا في النازِلينَ نَزيلُ
أي:
قومٌ إذا استنبحَ الأضيافُ كلبهُمُ
قالوا لأمّهِمِ: بُولي على النّارِ
فتُمْسِكُ البَوْلَ بُخْلًا أنْ تجودَ بهِ
وما تبولُ لهم إلا بمقدارِ
أي:
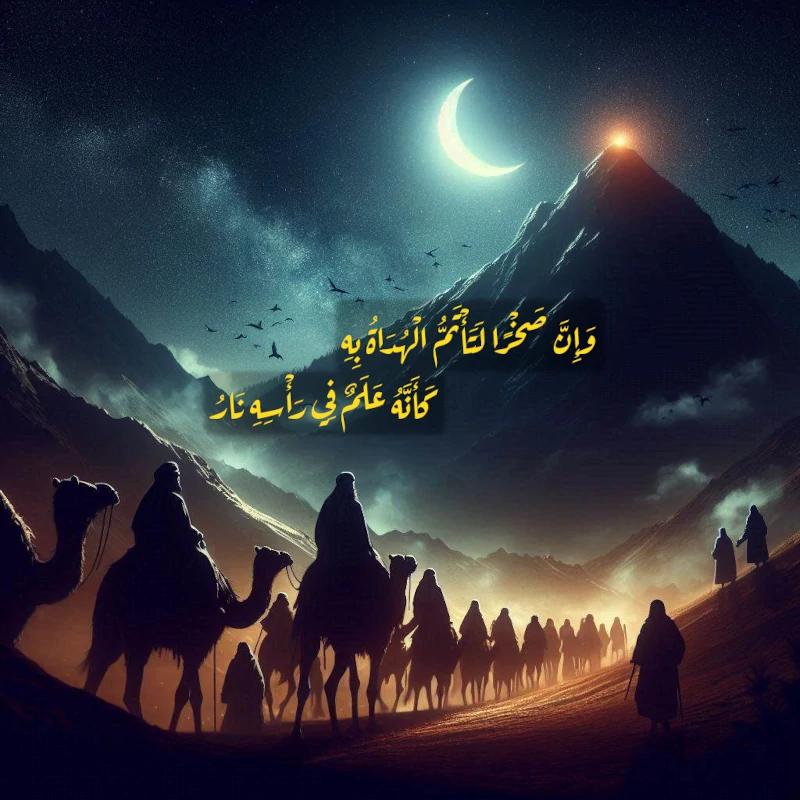
جَلْدٌ جَمِيلُ الْمُحَيَّا كَامِلٌ وَرِعٌ
وَلِلْحُرُوبِ غَدَاةَ الرَّوْعِ مِسْعَارُ
والجَلَد أظنك تعلمه، وهو قوة التحمل والصبر،
والسَعْر هو تهييج النار وإيقادها، ونقول
تقول الشاعرة:
نَحّارُ راغِيَةٍ مِلجاءُ طاغِيَةٍ
فَكّاكُ عانِيَةٍ لِلعَظمِ جَبّارُ
أَطْعِمُوا الجَائِعَ، وعُودُوا المَرِيضَ، وفُكُّوا
، وسُمي كذلك لعنائه ومشقته،
حَمَّالُ أَلْوِيَةٍ هَبَّاطُ أَوْدِيَةٍ
شَهَّادُ أَنْدِيَةٍ لِلْجَيْشِ جَرَّارُ
فَقُلْتُ لَمَّا رَأَيْتُ الدَّهْرَ لَيْسَ لَهُ
مُعَاتِبٌ؛ وَحْدَهُ يُسْدِي وَنَيَّارُ
الكلمتان يُسدي
ونَيَّار
بينهما تضاد، فنقول
لَقَدْ نَعَى ابْنُ نَهِيكٍ لِي أَخَا ثِقَةٍ
كَانَتْ تُرَجَّمُ عَنْهُ قَبْلُ أَخْبَارُ
وابن نَهيك يبدو أنه اسم رجل،
فَبِتُّ سَاهِرَةً لِلنَّجْمِ أَرْقُبُهُ
حَتَّى أَتَى دُونَ غَوْرِ النَّجْمِ أَسْتَارُ
والشاعرة تقول:
وربما تقصد بالنجم أخاها صخرا، فيكون المعنى
لَمْ تَرَهُ جَارَةٌ يَمْشِي بِسَاحَتِهَا
لِرِيبَةٍ حِينَ يُخْلِي بَيْتَهُ الْجَارُ
وَلا تَرَاهُ وَمَا فِي الْبَيْتِ يَأْكُلُهُ
لَكِنَّهُ بَارِزٌ بِالصَّحْنِ مِهْمَارُ
وَمُطْعِمُ الْقَوْمِ شَحْمًا عِنْدَ مَسْغَبِهِمْ
وَفِي الْجُدُوبِ كَرِيمُ الْجَدِّ مِيسَارُ
وقولها كريم الجَدّ
أي كريم العطاء،
قَدْ كَانَ خَالِصَتِي مِنْ كُلِّ ذِي نَسَبٍ
فَقَدْ أُصِيبَ فَمَا لِلْعَيْشِ أَوْطَارُ
كان خالصتي: أي كان ما يكفيني ويخلص له ودي، والأوطار: الحاجات، والمفرد وطر. تقول الشاعرة:
مِثْلُ الرُّدَيْنِيِّ، لَمْ تَدْنَسْ شَبِيبَتُهُ
كَأَنَّهُ تَحْتَ طَيِّ الْبُرْدِ أُسْوَارُ
جَهْمُ الْمُحَيَّا، تُضِيءُ اللَّيْلَ صُورَتُهُ
آبَاؤُهُ مِنْ طِوَالِ السَّمْكِ أَحْرَارُ
مُوَرَّثُ الْمَجْدِ مَيْمُونٌ نَقِيبَتُهُ
ضَخْمُ الدَّسِيعَةِ فِي الْعَزَّاءِ مِغْوَارُ
فَرْعٌ لِفَرْعٍ كَرِيمٍ غَيْرِ مُؤْتَشَبٍ
جَلْدُ الْمَرِيرَةِ عِنْدَ الْجَمْعِ فَخَّارُ
فِي جَوْفِ رَمْسٍ مُقِيمٌ قَدْ تَضَمَّنَهُ
فِي رَمْسِهِ مُقْمَطِرَّاتٌ وَأَحْجَارُ
تقول الشاعرة:
طَلْقُ الْيَدَيْنِ بِفِعْلِ الْخَيْرِ ذُو فَجَرٍ
ضَخْمُ الدَّسِيعَةِ بِالْخَيْرَاتِ أَمَّارُ
لقد كررت نفس العبارة ضخم الدسيعة
لم ذلك؟
لعلها قالت ضخم الدسيعة
مرة واحدة، ولكن تكررت بعد نقل ورواية القصيدة رجلا بعد آخر حتى وصلت لنا مكررة، ولعلها كررتها فعلا تأكيدا لما تقول، لا ندري.. المهم،
لِيَبْكِهِ مُقْتِرٌ أَفْنَى حَرِيبَتَهُ
دَهْرٌ وَحَالَفَهُ بُؤْسٌ وَإِقْتَارُ
هل تعلم من المقتر وما الإقتار؟ ما دليلك من القرآن الكريم؟
وَرُفْقَةٌ حَارَ هَادِيهِمْ بِمَهْلِكَةٍ
كَأَنَّ ظُلْمَتَهَا فِي الطُّخْيَةِ الْقَارُ
عَبْلُ الذِّرَاعَيْنِ قَدْ تُخْشَى بَدِيهَتُهُ
لَهُ سِلَاحَانِ أَنْيَابٌ وَأَظْفَارُ
مَشَى السَّبَنْتَى إِلَى هَيْجَاءَ مُضْلِعَةٍ * لَهُ سِلَاحَانِ أَنْيَابٌ وَأَظْفَارُ
، وقد يكون التكرار لنفس السبب الذي ذكرناه سابقا.. تقول الشاعرة في هذا البيت
لَا يَمْنَعُ الْقَوْمَ إِنْ سَالُوهُ خُلْعَتَهُ
وَلَا يُجَاوِزُهُ بِاللَّيْلِ مُرَّارُ
لقد كررت الشاعرة الحديث عن كرمه وجوده، وأظنها صادقة في قولها، ما أجمل السيرة الحسنة بعد الموت..
عد لبداية القصيدة واقرأها كاملة.. انظر هل صرت تفهمها كاملة أم لا
يقول عمرو بن كلثوم في معلقته:
فَمَا وَجَدَتْ كَوَجْدِي
أَضَلَّتْهُ فَرَجَّعتِ الحَنِيْنَا
فيقول لم تجد كوجدي ناقة أضلت ولدها فظلت تردد حنينها
.
ما معنى الوجد هنا؟الإجابة
وما معنى الحنين هنا؟الإجابة
اشرح البيت بأسلوب بسيط سهل الفهم، مع العلم بأن الشاعر يتحدث عن فراقه عن حبيبته.
يقول عنترة بن شداد في معلقته:
وَحَشِيّتِي سَرْجٌ على عَبْلِ
نَهْدٍ مَرَاكِلُهُ نبيلِ الْمَحْزِمِ
فيخبر أن فراشه هو ظهر خيله عبل الأطراف ضخم الأرجل الراكلة سمين البطن.
ما معنى عَبل الأطراف
؟ اشرح البيت بأسلوب أسهل من أسلوبي 🙂الإجابة
يقول عنترة في قصيدة منسوبة له:
إِذا الريحُ هَبَّت مِن رُبى العَلَمِ
طَفا بَردُها حَرَّ الصَبابَةِ وَالوَجدِ
لن أسألك عن الوجد مجددا، ولكن ما معنى العلم
هنا؟ وما دليلك من القرآن الكريم؟الإجابة
يقول أحمد شوقي في الغزل:
أذعَنَ للحُسنِ عصيُّ العِنانْ
وحاولتْ عيناك أمرًا فكانْ
يعيش جفناك لبثِّ المُنى
أو الأسى في قلبِ راجٍ وعانْ
ما معنى عانٍ
؟ وما معنى البيت؟الإجابة
أذعن تعني خضع، فابحث هل ذكرت تلك الكلمة في القرآن الكريم؟ ما معنى تلك الآية؟
يقول الأعشى في مقدمته الغزلية:
قَد نَهَدَ الثَديُ عَلى صَدرِها
في مُشرِقٍ ذي صَبَحٍ نائِرِ
لَو أَسنَدَت مَيتًا إِلى نَحرِها
عاشَ وَلَم يُنقَل إِلى قابِرِ
حَتّى يَقولُ الناسُ مِمّا رَأوا:
يا عَجَبا لِلمَيِّتِ الناشِرِ
ما النحر؟ وما معنى البيت؟الإجابة
أين ذكر النشور في آية أخرى بمعنى الحياة بعد الموت؟